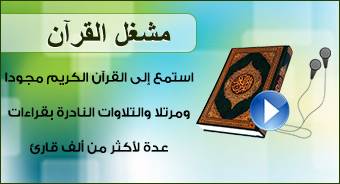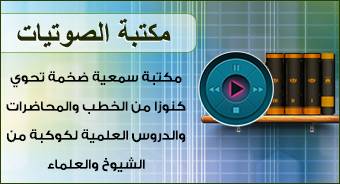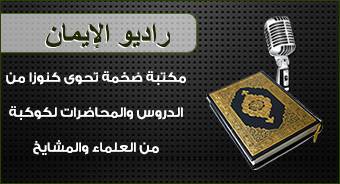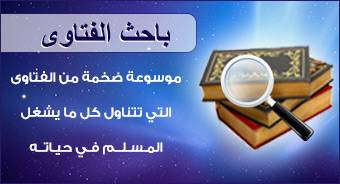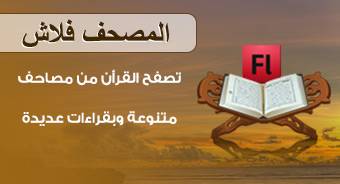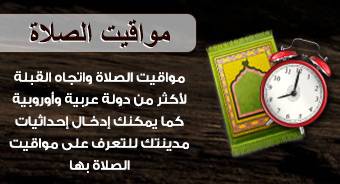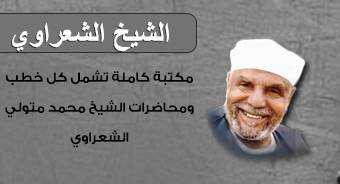|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
والذكاء: سرعة الفطنة، والفعل منه ذكى يذكى، والشيء الذي تذكى به: ذكوة. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1167، ومعجم المقاييس ص 388، والتوقيف ص 350].
وشرعا: هي السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختيارا، وأنواعها أربعة: الذبح: هو قطع مميز مسلم أو كتابي بمجرد جميع الحلقوم والودجين بلا رفع طويل قبل التمام بنية. النحر: وهو طعن مميز مسلم أو كتابي بلبة بلا رفع طويل قبل التمام بنية. فلا يشترط فيه قطع الحلقوم والودجين. والعقر أو الصيد: وهو جرح مميز مسلم بمجرد أو حيوان صيد معلم حيوانا وحشيّا غير مقدور عليه إلا بعسر بنية وتسمية. وما يموت به ما ليس له نفس سائلة: وهو كل فعل يزيل الحياة بأي وسيلة عن كل ما لا دم له، كالجراد، والدود، وخشاش الأرض، فهو ذكاة له ولو لم يعجل موته كقطع جناح أو رجل أو التقائه بماء حار. فأولى قطع رأس بشرط نية ذكاته وتسمية عليه. والذكاة: الذبح، وكذلك التذكية. والذكاء في اللغة: تمام الشيء وكماله، ومنه الذكاء في السّنّ والفهم: (تمامها)، وفرس مذك: استتم قروحه، فذلك تمام قوته، ورجل ذكىّ: إتمام الفهم، وذكيت النّار: أتممت وقودها، وكذلك: {إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة: الآية 3] أي: ذبحتموه على التمام. الذكاة، يقال: (ذكى الشاة ونحوها): أي ذبحها، فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع. [شرح حدود ابن عرفة 1/ 199، والنظم المستعذب 1/ 230، والروض المربع ص 504، والكواكب الدرية 2/ 65- 73].
والفرق بينه وبين الحفظ: أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه، والذكر يقال اعتبارا باستحضاره، ويطلق على حضور الشيء بالقلب أو القول، لهذا قيل: الذكر ذكران، ذكر بالقلب وذكر باللسان، وكل واحد منهما ضربان، ذكر عن نسيان، وذكر لا عن نسيان، بل من إدامة الحفظ، وكل قول يقال له: ذكر. والذكر بمعنى: الشرف، كقوله تعالى: {لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ} [سورة الأنبياء: الآية 10]: أي شرفكم وما تذكرون به، وقوله تعالى: {بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ} [سورة المؤمنون: الآية 71]: أي بما فيه شرفهم. [بصائر ذوي التمييز 2/ 9- 15].
والذّل: ما كان من جهة الإنسان نفسه لنفسه فمحمود: {أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [سورة المائدة: الآية 54]، وقوله تعالى: {فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا} [سورة النحل: الآية 69]: أي منقادة غير مستعصية. [بصائر ذوي التمييز 2/ 17، 18].
والذمة: العهد والكفالة، كالذّمامة والذّم. [بصائر ذوي التمييز 2/ 18].
[بصائر ذوي التمييز 2/ 18].
[بصائر ذوي التمييز 2/ 19، 20].
والرؤوس: ما يلبس في التنانيز ويباع في السوق. ورأس المال: أصل المال بلا ربح ولا زيادة، قال الله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ} [سورة البقرة: الآية 279]. [المعجم الوسيط (رأس) 1/ 331، والاختيار 3/ 440، والموسوعة الفقهية 22/ 645].
وقال بعضهم: (الرأي): هو إجالة الخاطر في المقدمات التي يرجى منها إنتاج المطلوب، وقد يقال للقضية المستنتجة من الرأي: (رأي). ويقال لكل قضية فرضها فارض: (رأي أيضا). والرأي: استخراج حسن العاقبة. [الكليات ص 480، وإحكام الفصول ص 52].
وقال آخرون: الرؤيا كالرؤية، جعلت ألف التأنيث فيها مكان تاء التأنيث للفرق بين ما يراه النائم واليقظان. والرؤية- بالهاء-: هي رؤية العين ومعاينتها للشيء كما في (المصباح)، وتأتي أيضا بمعنى العلم، فإن كانت بمعنى النظر بالعين فإنها تتعدى إلى مفعول واحد وإن كانت بمعنى العلم فإنها تتعدى إلى مفعولين. وحقيقة الرؤية: إذا أضيفت إلى الأعيان كانت بالبصر كقوله صلّى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». [البخاري 3/ 35]، وقد يراد بها العلم مجازا. والرؤية لغة: إدراك الشيء بحاسة البصر. وقال ابن سيده: (الرؤية): النظر بالعين والقلب، وهي مصدر: (رأى وتراءى القوم): رأى بعضهم بعضا، وتراءينا الهلال: نظرنا، وللهلال عدة معان منها: القمر في أول استقبال الشمس كل شهر قمرى في الليلة الأولى والثانية، قيل: والثالثة، ويطلق أيضا على القمر ليلة ست وعشرين وسبع وعشرين لأنه في قدر الهلال في أول الشهر. وقيل: يسمّى هلال إلا أن يبهر ضوءه سواد الليل وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة، والمقصود برؤية الهلال: مشاهدته بالعين بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر السابق ممن يعتمد خبره وتقبل شهادته فيثبت دخول الشهر برؤيته. والغالب في استعمال الفقهاء: هو المعنى الأول، وذلك كما في رؤية الهلال ورؤية المبيع، ورؤية الشاهد للشيء المشهود به وهكذا. وقال الجرجاني: (الرؤية): المشاهدة بالبصر حيث كان في الدنيا والآخرة. [المعجم الوسيط (رأي) 1/ 332، وشرح الزرقاني على الموطأ 4/ 350، والموسوعة الفقهية 3/ 241، 22/ 7، 15، 22، 23].
[النظم المستعذب 2/ 202].
والرائحة: عرض يدرك بحاسة الشم، وقيل: لا يطلق اسم الريح إلّا على الطيب. [المعجم الوسيط (روح) 1/ 394، والموسوعة الفقهية 22/ 40].
[المعجم الوسيط (روض) 1/ 395، والمطلع ص 267].
وأصل هذا المصطلح اللغوي: (ربغ القوم في النعيم): أقاموا. والربغ: التراب، والرابغ: من يقيم على أمر ممكن له، والجحفة: ميقات الإحرام لأهل الشام، وتركية، ومصر، والمغرب، وتقع قرب ساحل البحر الأحمر وسط الطريق بين مكة والمدينة. وقد اندثرت الجحفة من زمن بعيد وأصبحت لا تكاد تعرف وأصبح حجاج هذه البلاد يحرمون من رابغ احتياطا، وتقع قبل الجحفة بقليل للقادم من المدينة وتبعد عن مكة (220 كيلومترا). [المعجم الوسيط (ربغ) 1/ 337، والموسوعة الفقهية 22/ 43].
أثبته وأقره. قال ابن جنى: يقال: (ما زلت على هذا راتبا): أي مقيما. ومن هنا ساغ استعمال الراتب والمرتب فيما يأخذه المستخدم من أجر ثابت دائم. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1230، والموسوعة الفقهية 22/ 44].
[المعجم الوسيط (روح) 1/ 394، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 465].
[المطلع ص 161].
والراحة: زوال المشقة والتعب، وأرحته: أسقطت عنه ما يجد من تعب فاستراح، ويقال: أراح في المطاوعة، و«أرحنا بالصّلاة». [أحمد 5/ 364، 371]: أي أقمها فيكون فعلها راحة، لأن انتظارها شق على النفس. [المصباح المنير (روح) ص 93، والمغني لابن باطيش 1/ 118].
[فتح الباري (مقدمة) ص 129].
المعينة والمعطية، واسترفده: طلب رفده. [المصباح المنير (رفد) ص 88، ونيل الأوطار 4/ 132].
[المصباح المنير (ركد) ص 90، والنظم المستعذب 1/ 15]. |